صدر مؤخرا كتاب «قراءات في الفن والأدب» للناقد "جمال الطيب" عن دار الأدهم لنشر والتوزيع، والذي لا يعتبر مجرد دراسة و تطواف مابين عوالم الفن والأدب، بل بمثابة بيان حب لمعنى الفن المصري والعربي، واحتفاء بمن صنعوا ذاكرته من مخرجين وكتاب ونقاد.
أبرز المحاور التي تناولها الكتاب
جاء الكتاب في 200 صفحة من القطع المتوسط تتوزع على محاور رئيسية: المسرح، السينما، الأدب، والرقابة، في نسق متكامل يجعل من كل فصل حكاية قائمة بذاتها.
المسرح... مرآة الروح وذاكرة المدينة
يفتتح الطيب كتابه بقراءة مسرحية تنبض بحنينٍ واضح إلى «مسرح الطليعة» وحقبة الإبداع التي قادها المخرج سمير العصفوري في سبعينيات القرن الماضي. يتناول الكتاب مسرحية «بارانويا» للمخرج محسن حلمي، والتي يرصد فيها تفاصيل العلاقة المعقدة بين الفن والمجتمع، بين خشبة المسرح وشارع القاهرة، بين الممثلة التي تصرخ في وجه القهر والمدينة التي تنام على أصواتها.
متابعة التحولات النفسية لشخصية البطلة وتحليل رموز النص ولغته البصرية
في قراءته الدقيقة لمسرحية «بارانويا»، يتابع الطيب التحولات النفسية لشخصية البطلة (ريم عبد القادر) ويحلل رموز النص ولغته البصرية، مستعيدًا زمنًا كان المسرح فيه مختبرًا للحرية وميدانًا للمقاومة الجمالية.
لا يكتفي بتوصيف العرض، بل يتأمل دلالاته الاجتماعية والأنثوية، وكيف تصبح الخشبة مساحة اعتراف ومساءلة ذاتية في مواجهة العنف الرمزي والواقعي ضد المرأة.
رصد الحركة المسرحية بعد ثورة يناير
ويمتد اهتمام الكاتب بالمسرح إلى رصد الحركة المسرحية بعد ثورة يناير 2011، عبر عرض تحليلي لكتاب جرجس شكري «الخروج بملابس المسرح»، فيضعنا أمام مسرحٍ يحاول استعادة دوره في لحظة الانكسار الوطني. يرى الطيب أن تلك المرحلة كشفت عن مأزق المسرح العربي: بين الارتجال الثوري والبحث عن لغة جديدة توازي الزلزال السياسي والاجتماعي الذي عاشته مصر والمنطقة.
السينما... من واقعية صلاح أبو سيف إلى حلم سعد القرش
ينتقل الطيب بسلاسة من خشبة المسرح إلى شاشة السينما، فيكتب عن الأفلام كما لو كان يصف حياة كاملة.
في قراءته لكتابات هاشم النحاس عن المخرج صلاح أبو سيف، يقف الطيب عند الفرق بين الصنعة والفن، وكيف استطاع أبو سيف أن يحوّل تفاصيل الحياة الشعبية إلى شعر بصري.
يحلل الطيب أفلامًا مثل «الفتوة»، «شباب امرأة»، «الوحش»، و*«بداية ونهاية»*، بوصفها مرايا لواقع اجتماعي متغير، ويكشف عن البعد الجمالي في الواقعية المصرية التي صنعها أبو سيف لتكون «دراما الناس العاديين»، حيث يتحول السوق، والحارة، والسرجة، إلى فضاءات فلسفية وإنسانية في آنٍ واحد.
ومن السينما الكلاسيكية ينتقل الكاتب إلى النقد المعاصر، مستعرضًا دراسات النحاس في «علم النفس والظواهر الإبداعية في السينما»، فيتأمل العلاقة بين الإبداع والوعي، وبين الموهبة والبيئة، وكيف أن العمل السينمائي لا ينجح بالقدرة التقنية فقط، بل بالانفعال النفسي الصادق القادر على خلق الدهشة.
هل الفن مطالبٌ بتقديم الحلول أم بطرح الأسئلة؟
يضع الطيب القارئ أمام قضية مركزية: هل الفن مطالبٌ بتقديم الحلول أم بطرح الأسئلة؟ ويجيب بأن الإبداع الحقيقي لا يقدّم أجوبة، بل يفتح أبوابًا للتفكير، وأن السينما التي تثير التساؤل تظل حية في الذاكرة أكثر من تلك التي تكتفي بالوعظ أو الرسالة المباشرة.
لا يفوت هذا الكتاب مناقشة صورة اليهود في السينما المصرية " فيكتب الطيب تحت عنوان عريض "الصورة السينمائية وأهميتها في نشر الفكر الصهيوني، ويناقش الطيب ماطرحه الناقد السينمائي "أحمد رأفت بهجت" عبر كتابه "اليهود والسينما في مصر والعالم العربي" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وماررصده الكتاب عبر صفحات التي وصلت ل 481 صفحة من القطع المتوسط، لحال اليهود في السينما ودروهم في الحياة والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في سنوات الذروة التي عاشوها في البلاد العربية منذ العشرينيات، وماقاموا به من احتكار لشركات الانتاج في مصر، وامتلاك دور العرض في مناطق مثل الاقصر والمنيا وجرجا وميت غمرومفر الدوار وغيرها ـ الى جانب ذلك يعرض سيطرتهم على الصحافة الفنية في مصر وبعض البلاد العربية. وكيف لعبوا دورا كبير ا في تجميل صورة اليهودي.
وفي فصول لاحقة، يتوقف عند تجربة الكاتب سعد القرش في كتابه «في مديح الأفلام»، بوصفه رحلة بين المهرجانات والمدن، من القاهرة إلى طنجة وأبوظبي. يقدم الطيب هذا الكتاب كـ«سيرة ذاتية للمشاهد»، حيث تتحول متابعة الأفلام إلى فعل حب ومعرفةٍ بالعالم.
يكتب القرش عن السينما كنافذة على الحياة، ويحتفي الطيب بهذا البعد الإنساني، معتبرًا أن الكتابة عن السينما هي كتابة عن الذات في مرايا الآخرين.
الرقابة... بين السلطة والإبداع
في الجزء الأخير من الكتاب، يتناول جمال الطيب دراسة حول تاريخ الرقابة على السينما المصرية، مستندًا إلى كتابات الناقد القدير سمير فريد، في محاولة لتأمل علاقة الفن بالسلطة منذ بدايات القرن العشرين.
يرى أن الرقابة لم تكن يومًا أداةً لحماية الأخلاق كما يُروَّج، بل كانت دائمًا مرآة للسلطة السياسية، تعكس مخاوفها وتوجهاتها، وتتحكم فيما يجب أن يُقال وما يجب أن يُنسى.
ويعيد القارئ إلى جذور الرقابة منذ قانون المطبوعات عام 1881 ولائحة التياترات عام 1911، وصولًا إلى القوانين الحديثة، مبرزًا أن تاريخ الرقابة هو في جوهره تاريخ الصراع بين الخيال والسيطرة.
يطرح الطيب، من خلال هذه القراءة، سؤالًا راهنًا: هل يمكن للسينما العربية أن تحقق حريتها الفنية في ظل منظومات بيروقراطية وثقافية تقليدية؟ ويقترح أن تجاوز هذا القيد لا يكون إلا بـ«ثقافة المشاهدة» — أي بتربية الجمهور على التلقي النقدي والفكر الحر، فالمتفرج الواعي هو الحصن الحقيقي ضد الابتذال والتضييق معًا.
يبقى ان هذا الكتاب لجمال الطيب يعد واحد من الكتب القليلة التي لا غنى للباحث والقارئ في تاريخ الفن والأدب العربي، كتاب ليس مجرد قراءة في الكتب بل هو كتاب يحاول البحث عن اجابات لاسئلة مازالت عالقة عن الحب والفن والحياة عن السياسة والتاريخ عن الراهن والماضي.
الكتاب اشبه بالمتحف، تتجاور فيه لوحات المسرح مع لقطات السينما ومقاطع الشعر والسرد، في سيمفونية واحدة عنوانها الإنسان.















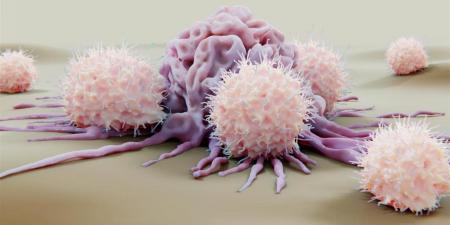



0 تعليق